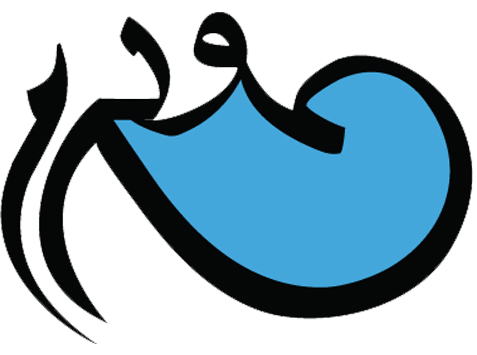في ظل التحديات المتزايدة التي يفرضها سيل المعلومات المضللة على المجتمعات، تزداد الحاجة إلى فتح حوارات جادة حول تأثيرها على فئة الشباب بشكل خاص، بوصفهم الأكثر حضوراً في الفضاء الرقمي والأكثر عرضة للتأثر به. ومن هذا المنطلق، سعدت بالمشاركة في فعالية “الشباب والوعي: تحديات في فضاء المعلومات المضللة” التي نظمتها مؤسسة ماعت في مصر عبر الإنترنت، والتي جمعت مجموعة من الخبراء والناشطين من دول عربية مختلفة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي.
شاركتُ إلى جانب ثلة من الزملاء المميزين: محمد الصادق من تونس، رندا محمد من اليمن، أنس أبو جودة من فلسطين، ولينا المومني من الأردن بالإضافة إلى منسقة الفعالية مارينا سامي من مصر. كان النقاش ثرياً ومتنوعاً، وتناول آليات عملية لإشراك الشباب في مواجهة التحديات المرتبطة بالمعلومات المضللة، وكيفية بناء وعي نقدي يحصن الأفراد والمجتمعات.
فيما يلي أنشر نص كلمتي الكاملة التي ألقيتها خلال الفعالية، آملاً أن تفتح مزيداً من الحوار والنقاش حول سبل تعزيز وعي الشباب في هذا المجال.
عنوان المحاضرة: أهمية إشراك الشباب في مكافحة المعلومات المضللة في الفضاءات الرقمية وأفضل الممارسات
تشهد منطقتنا العربية، ولا سيّما الدول التي تمر بأزمات تتجاوز حدودها الجغرافية، تحديات متزايدة في التصدي للمعلومات المضللة. وللأسف، لا الحكومات ولا وسائل الإعلام التقليدية أظهرت حتى الآن قدرة فعّالة على التعامل مع هذه الأزمة.
من هنا، يبرز الدور المحوري للشباب في هذه المواجهة. فهؤلاء يمتلكون مزيجاً فريداً من المهارات التقنية والحماسة للتغيير، إلى جانب قدرتهم على الوصول إلى أقرانهم وسائر فئات المجتمع بطرق مبتكرة وفعّالة. ولا بدّ من التذكير بأن الشباب يشكّلون حوالي 60% من سكان العالم العربي، وبالتالي فإن تمكينهم يشكّل خط الدفاع الأول ضد التضليل الرقمي.
لماذا تنتشر الأخبار المضللة
ولإعطاء بعض الإحصاءات ذات الصلة، أظهرت دراسة أعدّتها جامعة جنوب كاليفورنيا أن 15% فقط من مستخدمي فيسبوك الذين يشاركون الأخبار باستمرار هم المسؤولون عن نشر ما نسبته 40% من الأخبار الكاذبة المتداولة على المنصة. كما كشف استطلاع للرأي في الأردن أن 32% من الذين يشاركون معلومات خاطئة يعتقدون أنهم يشاركون معلومات مهمة، مما يدل على أن نحو الثلث يقومون بذلك من دون إدراك أن ما ينشرونه غير دقيق، ما يجعل الخطر أكبر، إذ إن المشكلة لا تكمن في النوايا بل في ضعف التقييم.
وتتفاقم هذه الظاهرة بشكل خاص في أوقات الأزمات والصراعات، حيث يُلاحظ ازدياد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيّما فيسبوك وواتساب، التي باتت تُعتبر من قِبل كثيرين بمثابة “الإنترنت” ذاته.
واتساب، تحديداً، تُعدّ من أكثر المنصات التي تنتشر فيها الأخبار المضللة بسرعة، وفق ما أظهرته دراساتي في سوريا والأردن ولبنان. إحدى الدراسات تشير إلى أن المستخدم العادي يتفاعل مع رسالة واحدة من كل ثلاث رسائل تصله، إما عبر الإعجاب أو إعادة الإرسال، ويقوم بفتح التطبيق خلال دقيقة واحدة من استلامه للرسائل، ويقضي عليه حوالي نصف ساعة يومياً، مما يعني أن حجم التفاعل والتأثير مرتفع للغاية.
وتكمن خطورة هذه الظاهرة في الكيفية التي تعمل بها خوارزميات هذه المنصات، والتي تعزز ظاهرة “غرف الصدى” أو Echo Chambers، فتقوم بعرض محتوى متشابه يرسّخ قناعات المستخدمين بدلاً من تحدّيها أو توسيع نطاق معرفتهم.
من هنا، تبرز أهمية إيصال المعلومات الصحيحة إلى الجمهور في أماكن تواجدهم، وعلى المنصات التي يستخدمونها فعلياً.
مبادرات عربية في تدقيق المعلومات
للأسف، كثير من المبادرات الشبابية في الوطن العربي، رغم كونها واعدة، لم تتمكّن من الاستمرار. وغالباً ما يعود ذلك إلى تركيزها على منصة واحدة فقط، أو إلى اختيارها لمساحات لا تتفاعل بالسرعة المطلوبة لمجابهة انتشار الإشاعات.
لأعود بالزمن إلى عام 2014، حين ظهرت مبادرة شبابية من الأردن، أطلقها شاب غير مختص بالإعلام، لكنها كانت تهدف إلى التحقق من المعلومات، وأسّست منصة “فتبينوا”، التي أصبحت لاحقاً واحدة من أبرز المبادرات العربية في هذا المجال. وعلى الرغم من تراجع حضورها لاحقاً أمام منصات منافسة مدعومة بشكل أكبر، فإنها ما زالت تواصل عملها حتى اليوم.
كما برزت مبادرات أخرى، مثل “تونس تتحرى”، التي أسسها شباب من نقابة الصحفيين في تونس بعد جائحة كورونا، وأيضاً منصة “كاشف” في فلسطين بالتعاون مع نقابة الصحفيين.
وفي لبنان، كان لي شرف المساهمة في تأسيس مبادرة “صواب”، وهي مبادرة شبابية لتدقيق المعلومات، تضمّ طلاباً من كليات الإعلام والصحافة. عملنا على تنظيم جلسات تدريبية مكثّفة، ومن خلالها تم اختيار نواة صغيرة انطلقت بنموذج يعتمد على مبدأ Grassrooting، أي إنشاء مجموعات واتساب محلية تتوزع على المناطق والمؤسسات الإعلامية، ترصد الإشاعات وتشاركها مع مجموعات مختصة للتدقيق والردّ ونشر المعلومات الصحيحة.
وعلى الرغم من أن العمل على منصات التواصل الأخرى كان أبطأ، فإن الاعتماد على واتساب ساعد في استمرارية المبادرة، لا سيّما في ظل حصولها على دعم معنوي ومادي مستمر، وهو ما يُعدّ ضرورياً لأي مبادرة تطمح للاستدامة.
إلى جانب التمويل، يواجه العديد من المبادرات تحدياً آخر يتمثل في غياب التطوير والتحديث على أدوات وأساليب العمل، لا سيّما تلك المرتبطة بالتحقق الرقمي، دون أن نحصر ذلك بمجال الذكاء الاصطناعي، بل يشمل حتى الأدوات البسيطة التي تُسهم في تحسين الكفاءة.
فخلال جائحة كورونا، درست عدداً من المبادرات في ليبيا، تونس، مصر، سوريا، ولبنان، وتبيّن أن العديد منها بقي على نفس المستوى الذي بدأت منه، دون تطوير أو تحديث، إما لأن القائمين عليها اعتقدوا أن أنظمتهم تعمل بشكل كافٍ، أو لغياب التوجيه المناسب نحو آليات التطوير. وفي الوقت ذاته، ظهرت مبادرات أخرى أكثر تطوراً وفاعلية.
أما من الناحية القانونية، فعلى الرغم من التحديات، فإن معظم المبادرات لا تواجه فعلياً خطراً قانونياً مباشراً في أنشطتها، خاصة وأن جزءاً كبيراً من عملها يقتصر على تدقيق المعلومات العامة دون التوغل في قضايا سياسية حساسة. ومع ذلك، لجأت بعض المبادرات إلى استخدام هويات مستعارة أو إلى نقل مقارها خارج بلدانها، كما فعلت منصة “تأكد” السورية التي سجّلت مقرها في تركيا، و”تحقق بالعربي” في إندونيسيا.
ولا يمكننا أن نغفل أيضاً الدور المتنامي للشباب العاملين داخل المؤسسات الإعلامية التقليدية، سواء في مصر أو لبنان، حيث بادرت بعض المؤسسات إلى إدماج مدققي معلومات ضمن كوادرها، أو أنشأت أقساماً خاصة للتدقيق تُدار بعقلية رقمية تُخاطب الجمهور على المنصات الحديثة بشكل فعّال.
نتائج الجهود
على الرغم من أن بعض العاملين في هذه المبادرات قد يشعرون أن أثرهم محدود، إلا أن ردود فعل بعض الحكومات العربية تشير إلى عكس ذلك. فقد بدأت بعض الجهات الرسمية في إنشاء وحدات خاصة للرد على الشائعات، سواء تحت مظلة وزارات الإعلام أو مؤسسات الدولة الأخرى، كما بدأت بعض الهيئات السياسية والدينية بتبنّي منهج تدقيق المعلومات، وإن كان وفقاً لأساليبها الخاصة.
تعزيز الجهود وتكاملها
خلال السنوات الأخيرة، كنت من بين مؤسسي “الشبكة العربية لمدققي المعلومات” تحت مظلة منظمة أريج في الأردن. وتكمن أهمية هذه الشبكة في تعزيز الشراكات العابرة للحدود بين المبادرات العربية، وتجنب تكرار الجهود. مثال على ذلك، خلال الحرب على غزة، ثمّة حاجة لتعاون حقيقي بين المبادرات في لبنان وسوريا واليمن وغيرها، بدلاً من العمل الفردي المتكرر.
وفي مؤتمر أريج الأخير، تم تكريم ثلاث منصات—”مسبار” من الأردن، “تحقق” من فلسطين، و”صواب” من لبنان—على مشروع مشترك أثبت فعاليته في رفع الوعي، وتقليل التكاليف، وتعزيز التكامل.
الأثر المجتمعي
بات من الواضح أن التفكير النقدي في التعامل مع المعلومات آخذ في التزايد بين مختلف شرائح المجتمع. أصبح الناس أكثر وعياً بأن ما يُنشر على الإنترنت أو واتساب لا يُمكن اعتباره حقيقة مطلقة. كما أن سلوكيات الأفراد بدأت تتغيّر، إذ يُلاحظ تزايد اللجوء إلى مدققي المعلومات، سواء بالسؤال المباشر أو عبر الإشارة إليهم على فيسبوك، ما يساهم في بناء “مناعة مجتمعية” ضد المعلومات المضللة.
لكن من الضروري أن لا تقتصر هذه الجهود على الشاشات فقط. يجب أن تمتد إلى فئات عمرية أصغر، لأن الأجيال القادمة ستكون المسؤولة عن مواصلة هذه المهمة.
لقد بدأتُ العمل في مجال تدقيق المعلومات منذ عام 2002، وإن لم أشارك معرفتي وتجربتي، فستضيع هذه الخبرة، وسيضطر الجيل القادم إلى إعادة اكتشاف هذا المجال من الصفر، مما يؤخر بناء مناعة المجتمع ضد التضليل ويُضعف خط الدفاع الأول الذي نسعى إلى ترسيخه.